الكفن والوصية.. أنا وحسن مطلك والفارة سميرة
 خضير ميري
خضير ميري(وهكذا... أهمل نفسه ليكمل النشيد الناقص. ضحك. ضحك. ضحك........)
دابادا
(ورأى اوليفر يزحف بسرواله الأبيض ذي العلامات النحاسية، ويبتسم بوداعة، ثم ينحني ليقطف العشب بأسنانه)
قوة الضحك في أورا 1987م
(1)
ليس هذا ضربا من الكتابة، ليس أسلوبا على ورق، وما نصيبه من الخيال إلا جمالاً يترنح على أمواج من الواقع وكان ذلك هو في قدومه المارق من هنا، ذات عراق، ذات ظلام لفنا واعتصر أعمارنا وصار ذلك الظلام نسيا منسيا، عندما يتعثر التاريخ بأقدام صبية يرممون فراغه الموحش ثم يبصقون على أباطرته وأغبياءه وجلاديه، ذلك أننا كنا ومازلنا نطوق الأرض بأكثر مما تستحق من المعنى ونحلب لها من القيم ما تجهله السماء في عماءها المبارك.
ومن ثم كانت لنا أغنية، أنا اعتقد بذلك، أنا واحد من الذين سرقوا حياتهم من فم الأسد والذئب والفار والذبابة والربابة والدبابة والرماية والسقاية والعائلة والدين والوثن وما يصدقون.. أنا الذي يتوزع في أكثر مني، ويتوالد لغة ولثغة ولهفة وعجالة وبصلة وبطيخة. اتكيس في جيبي، وأتجلد في جلدي ولي الله في ضياعي عنه ورضاعتي التراب والماء والنار والكتابة كنت قد رايته حيا وشاهدته مغامرا ومجنونا وغير مصدق به أحد فكنت قد ذهبت قبله إلى الجنون الخائف الرعديد وكان قد ذهب قبلنا إلى بطولته المنتظرة فما مات قط لكنه قتل مبتسما على الأغلب وغير نادم لأنه على فرديته الضيقة لصالح موته الجمعي، لأنه على سرديته الأولى يبتكر حكايته وذروتها ونهايتها فيكون بذلك كله كائن وكله مكنون.. مجنون ومجنون ومجنون وأنا أرى.. السقوط من رأسي، من أعلى مسراتي الأولى، أفكر فيه الآن وههنا، اجلس وحيدا في بار الانتعاش القابع في ورك شارع الرشيد أتنفس دخان المكان واشرب نعاس مصابيحه الكابية، عدت للتو من رحلتي القاسية من الجنون والعسل محملا بأطياف ناشزة للعقل الذي غادرته مرغما، صرت اكثر نسيانا من قبل اشد خوفا مني واكثر حرصا على حياتي التافهة التي استعادة نفسها من مخالب العدم ومجانية الموت فيه، لعله الصواب الأثول الذي لفني يوما ما ولعق مؤخرتي وتبول علي.
الموسيقى التي يعزفها جهاز التسجيل كانت لام كلثوم هذه ليلتي وهذه ليلة أخرى تشدني إليه وتمد خيوط شعرها الليلي بعيدا عبر أوتاد الدخان المنفوث في وجه الزمن العراقي المشحون بالمجهول والغني والسائب والمسكوت عنه والمذبوح والمشلوح والنيئ والقميء والمسلوخ من فروة الرأس والمدسوس والممسوس والملحوس والناتئ والمرشوش بعطر الكلام وزيفه.. وياله من زيف!
وكنت أنا قطعة من العبث، نزوة قططية، بقايا أفكار محفوظة وركام من أوراق الكتب. كنت قبل ذلك مجرد صبي يقرأ ويثرثر وينز أفكاراً.. إلا أن (أردال) الحزين كان حينها أكثر صمتاً، هو الذي صار مهندساً جاداً يعمل في (شركة حمورابي للمقاولات) ولم يكن الموعد مناسباً لي:
ـ انه بار الانتعاش، أنت تعرفه جيداً.
ـ البار نفسه؟
ـ نعم.
قال أردال.. وفكرت..
ـ بار للبيرة فقط، كم أكرهه!
هكذا كنت لا أحب سوى العَرق وما أدراك ما هو؟ عرق العصرية أفضله على عرق أبي نؤاس الذي يترك في حلقومي خيط مرارة تبعث على الغثيان ولكن البيرة، آها، إنها تنعس ولا تنعش وتُبوّل كثيراً وتُرهق راس مال الجيوب. ويصبح الانتعاش مضغوطا بميتافيزيقا الشعر المفتوحة على مصراعيها، مع أردال وأنفه المنقاري وطبقة الباز التي تتكلم فيه، انه يهمس لي عن آخر سوف تراه بعد قليل، ولكن لا عليك انه مجرد فكرة سردية، أضغاث أحلام ومزيداً من الضحك الغجري الأصيل!
ـ ماذا عن ابن عربي؟
ـ انه باهض الثمن وطبعته رديئة.
ـ وهو؟ هل هو غجرياً؟
ـ من هو؟
ـ أعني ذلك الحسن مطلك؟
وجلب لنا زنبور مزيداً من الباقلاء المزيتة، انه زنبور في حركته الدؤوبة ودورانه الحلزوني، هكذا نفتتح الليلة الليلة، وكانت هناك هذه ليلتي موسيقى بلا كلمات، وبكلمات أقل قرأ أردال القصيدة نفسها التي يرفض نشرها مطلقا وهي بناء هائل من الدلالات والرؤى والتهويمات، إنها تهدف أن تتكون كأفضل قصيدة في العالم.. وكأفضل قصيدة في العالم لابد من أن لا ترى النور مطلقاً. ولم ترَ النور كما أراد اردال أو كما أراد الله لا فرق، إنها ليلتي ومضارب عرسي وأوان ضربي على الناي، وجلب زنبور مزيداً من البيرة (فريدة) وهو يمسح كفيه بكفيه.
ـ مع الباقلاء؟
ـ مع الباقلاء.
وكان اردال مترقبا، متحسبا لمجيء حسن مطلك وكنت لا أعرفه، لا أعرف عنه شيئاً سوى أنه فاز قبل أيام بقصة مذهلة وغريبة (عرانيس).
ـ هل قرأتها؟
ـ نعم.
ـ ما هو رأيك؟
كنت مشغوفاً بفكرة الأسلوب أن تتلوى الكلمات وأن تمتص نفسها بنفسها وتتنفس واقفة.. أن يكون العمل الأدبي أعجوبة وفرادة نوعية ولكن الأفكار كانت تتسلط علي أكثر، كنت ما زلت منقوعاً بالفلسفة ومذاهب الكبار مأخوذا من الخلف وغير صريح كفاية. كنت ثعلباً ولغوياً وصاحب مرجعيات لا تعد ولا تحصى وكانت الأضواء تتحرك قرب أنفي، شاب في الثامنة عشر من عمره يصافح هيجل وماركس وسارتر وكامو وابن عربي وهيدجر وكل من لف لفهم
ـ أرابت، اندليت المكان يا أردال؟
نهض أردال وصافح رجلاً متوسط القامة، ممتلئ صحة، منحته أضواء البار ظلالاً رمادية وأكسبته بعداً لم أكن أجيد تحديده بعد
ـ انه خضير ميري
قال له أردال ذلك، لم يلتفت إلي وانشغل بتعديل كرسيه الفخم المزعج قليلاً، تمطق بشفتيه وقال:
ـ الأكل.. هينه أكو أكل؟
وشعرت بعدم ارتياح واضح، كان يبدوا قائماً بذاته، غير مؤدب حتى، وله أسلوب خاص بتحريك ملامح وجهه،
ضحك بلا مناسبة وخبطني على ظهري خبطة ثقيلة:
ـ أنت ميري إذاً؟
ـ نعم، كنت قد حدثتك عنه.
أجاب أردال نيابة عني، كان يبدو وكأنه يريد تفادي خلل ما، أو لعله شعر بان سلوك حسن مطلك لم يكن مناسباً، وكنت في لحظتها أرغب بالإيقاع به أو إحراجه على الأقل، إلا أن مرحه اللذيذ وتلقائيته حالت دون ذلك
ـ هل تشرب؟
ـ أنا، ههههه أشرب البحر وأرجعه عطشانا.
ثم قال:
ـ لا تزعل، اني أحب الهزار، قوة الضحك الضحك الضحك
حاولت أن أواصل كلامي عن أفكار كنا تبادلناها أنا واردال ولكن الزنبور تدخل ووجه طلبا إلى حسن
ـ لا لا أشرب الشرب يجعل معدتي منفوخة.
ثم قال اردال وقد احتقن وجهه
ـ قليل من الويسكي
ـ الويسكي آه، نعم بصحبة الفيلسوف.
ثم التفت إلي وركز نظره علي
ـ هل أنت فيلسوف؟
ولم أفهم أيعد ذلك سؤالاً أم استهزاءا؟
كانت البيرة تفور في أمعائي. كنت عفتها تسخن سهواً مني وصارت الباقلاء أكثر صلابة إلا أن حسن أراد أن يعرب عن حُسن نيته فقال:
ـ لا تقلق لقد قرأت لك ما يكفي، لا أعرف أين أنت..
ـ وأين أنا؟
ـ هنا في بار الانتعاش طبعاً هههههههههه
ونادى أردال زنبور فطار إلينا بقليل من الويسكي
ـ على شرف حسن
قال اردال
ـ على شرف (عرانيس).
قال حسن مطلك...
ورحت أنظر إليه نظرة برويفيلية فوجدت غمازة محببة في زوايا شفتيه وكان هو حليقاً تماماً ومبتسم رغم أنفه وله مواصفات أخرى لرجل لا تردد لديه. وعرفت أن أردال كان قد عد هذه الأمسية للاحتفال بحسن مطلك وأن حسن هو الذي طلب التعرف إليّ، وكان أسلوبه ذاك مبيتا ليعرف من خلال الاستفزاز نوعية الفتى الذي كنته والذي أخذني سكري مأخذا صعباً فصرت أحاول التطاول عليه بحق أو بدونه وكان هو يدوزن كأسه جيداً ويتحدث بغرور مناسب عن قدراته الروائية التي لم نكن نعرفها وسرقت الجلسة من يدي ورحت أتحول إلى مصغي ليس إلا، وهذه لم تكن عادتي وكان الزنبور يسقني بيرتي وكان أردال يساند حسن وكنت أتسرع بشربي راغباً بالنهوض سريعاً والانصراف عن هذا الكائن الذي أخذ يشدني إليه بسوء طوية ربما أو لعلها نوعا آخر من الحضور القنفذي الغامض لهذا الرجل الشرقاطي الذي مازالت قرويته بادية للعيان وصراحته لا تسر عدو ولا صديق. نهضت، وطلب أردال توصيلي بينما قال حسن مطلك:
ـ فرصة سعيدة.
لم أرد على المجاملة وذهبت مترنحاً إلى الخارج يضربني هواء بغداد وتدوخني شحة الإنارة فيها في ليل بغداد الثمانيني العجوز العبق برائحة الخوف والحرب والسكر والأقدار وكان اردال قد قال لحسن
ـ لا بأس من اللقاء غداً.
ولم التفت إلى حسن، ولم أرغب بلقائه مرة أخرى، وأنا أتضور جوعاً للإطاحة به، ولكن لا بأس من جلسة أخرى.
.. لم أكن في واقع الحال راغباً بها.
(2)
لا تقدم الرغبة شيئاً مفيداً دائماً، وليس صحيحاً أن العلاقة الإنسانية تحتاج إلى مقدمات مناسبة لكي تتحقق ولعل بعض الشخصيات لا يرغب الواحد منا أن يأخذها على محمل الجد إلا بعد لأي، بعد حين، بعد معرفة أوفر ولكن من العصي علي أنا شخصياً أن أتمرن على علاقة شائكة منذ البداية مع حسن مطلك. لم أكن أود لقاءه، هذا ما كنت أردده لنفسي وأنا اجلس في مقهى البرازيلية وكنت أطالع كتاب (ضياع في سوهو) لكولن ولسن بصحبة فنجان صغير من القهوة كان رحيم يوسف قد منحني إياه بسخاء ولعلني كنت أتعجل في أعماق نفسي أن يأتي الليل سريعاً وأن يحين موعدي مع اردال ولأنني لا أضمن مواعيد اردال وتقلباته المفاجئة وأحيانا تغيبه البوليسي الغامض فإنني كنت أشعر بالنكبة، لا ليس النكبة، ولكنه شئ من الرغبة في معرفة حسن أكثر أو العكس في عدم معرفته أو النيل منه أو.. أو............
كان رحيم يوسف يحدثني عن جمال قصة (عرانيس) بعد أن أخبرته بأنني كنت مع حسن مطلك ليلة أمس وأنني غير معجب بسلوكه القروي، ولكنه لم يبالي. كنت حزينا بعض الشيء وأنا أفكر بقبولي طالبا في أكاديمية الفنون الجميلة وكنت ارغب في قسم الفلسفة في جامعة بغداد وصار الوقت ثقيلا والبرازيلية تشعل مصابيحها وأنا بلا نقود كالعادة ولا أعرف ما إذا كان رحيم يوسف سوف ينقدني شيئاً أم لا، لم أساله لكي لا أُصدم ولكنه حدس ما كنت أفكر به فقال لي:
ـ لا عليك، اليوم ربعك طالع.
ـ اشلون؟
ـ بعت ثلاثية محمد ديب اللي سرقتها من أبو عوف.
ـ ليش يمعود؟
ـ لا عليك عندي نسخه ثانية منها
إلا أنني لم اكن أفكر بربع عرق في بار الحمراء المتواضع الكائن على شارع أبي نؤاس بل أفكر بالانتعاش وموعدنا مع حسن مطلك هناك، ونهض رحيم يوسف مستندا على ساق واحدة ووضع نقودا في كفي وحمل كيس مسروقاته من كتب هذا النهار، وما أن هم بالذهاب حتى صرخت به
ـ والقهوة؟
ـ مدفوعة من حسن العاني.
وحسن العاني هو المالك الشرعي لمقهى البرازيلية التي كانت واحدة من معالم الأمكنة الثقافية في شارع الرشيد وهو صاحب (الدار العربية للموسوعات) التي ستكون على موعد لطباعة (دابادا) رواية حسن مطلك الأولى ورائعة الأدب العربي بلا منازع. وكان بار الانتعاش يقع إلى جانب الدار نفسها، وهي في الوقت نفسه المكتبة الأكاديمية، وعبر هذا الثالوث المقدس والمدنس والمتنفس من بار ومكتبة ومقهى آثر حسن مطلك أن يجلس قدره من طعام الكتابة وان يزحف عبر هذا الثالوث الغريب باتجاه تاريخه الشخصي وخلوده الأدبي الذي لم يكن يخطر لنا ببال كما لم يكن يخطر لي أن أجده جالسا بمفرده بعد قليل في نفس الطاولة التي جلسنا عليها ليلة أمس يكتب شيئا ما سرعان ما خبئه وهو يرتدي بدلة رائعة وكأنه ممثلاً خرج تواً من اللكيشن وكان الزنبور قد جلب له استكانة من الشاي في واحدة من الحالات غير المسبوقة في بار الانتعاش. كنت أرتدي سترة من القش هكذا وصفها حسن مطلك ساخراً وان أحشو تحتها قميصا غير مكوي وسرعان ما قال لي:
ـ لدينا وقت لنشتري لك شيئاً من الألبسة المناسبة.
ولكنني رفضت خجلاً وصرت مباغتاً أكثر في سلوكه الغريب إزائي. لم أكن صديقه بعد، لم نلتق إلا عابرا ليلة أمس، ولم أكن أطيقه حتى، من يكون هو ذلك القروي الشرقاطي الفائز في مسابقة للقصص القصيرة؟ كنت أمور غيضا وربما حرصا عليه. وكان هو يدفعني بميانة وسرعان ما صرنا بقفا البار في قيصيرية جانبية لشارع الرشيد وغبنا قليلاً في داخل محل أنيق اخطبوطي الشكل ثم خرج أمامي ولحقت به وأنا أسير ببطء مرتدياً بنطالاً أسود وجاكيتة سوداء ثقيلة ومناسبة، وعلى فانلتي البيضاء المتسخة قميص بياقة واسعة وربطة عنق حمراء منقطة، وكنت بذلك قد أصبحت عريساً، هذا ما رآه اردال فيّ وفي هيئتي الجديدة.
ـ والآن أريد شيئاً من الويسكي احتفالاً بالهيئة الجديدة.
وضحكنا معاً، وكنت ماخوذاً بأسلوب هذا الرجل الغريب واختياره لمفرداته الوصفية وسرعان ما أفسدت الليلة عليه فأخبرته بأنه لا يعرف شيئا عن الكتابة وأنه مجرد كان قد حصل على جائزته الأولى بفضل الأغبياء من المشاركين من أمثاله، وكان هو يضحك بعناد ويمط شفتية ويعنى كثيرا بأقداح المزمزات التي كان يجلبها زنبور بإمرته هو لا بمشيئة اردال الذي كان يخشاه قليلاً ويستمع إليه بتعاطف ظاهر للعيان، وكان اردال يتطلع إلى ساعته وهو يهم بالانصراف لأسباب أجهلها، وكان يود أن نفض الجلسة معاً لولا أنه عرف من حسن بأنه لا ينوي الذهاب وعرف مني بأني راغباً في المكايدة وإرهاق حسن لا لشيء إلا لأنه لم يحسن معاملتي، وأنا أنوي أن أتقيئ كل ما قرأته أمامه، هكذا من أجل أن يكن لي احتراماً أكبر وأن يعرف من أنا
ـ من أنت؟
هذا هو السؤال الذي أطلقه بوجهي حسن مطلك وراح يحدثني بلهجة جادة اكثر مما توقعت عن القراءات التي بحوزته إلا انه قال رأياً غريباً بعد أن عصر ليمونة يتيمه في ماعون اللبلبي.
ـ العمل الأدبي يتجرد عن الزواحف القراءية، الكتب الكثيرة تعيق الكتابة أليس كذلك؟
فقلت له
ـ مبكراً عليك كلاماً كهذا.
مال بوجهه إلى جهة بعيدة وكان يكتم ضيقاً كان عالقا بين شفتيه
ـ اسمع، أنا لا أبحث عن دروس في المعرفة والجمال بكر لكل من يحرثه.
ـ ولكن كل ما هو كتابة هو معرفة.
ـ من حيث المنطق هذا صحيح.
فقلت له
ـ إذن؟
ـ لا، الكتابة تضيق ذرعا بالمنطق، الكتابة مغامرة، تعارض مع ما هو عقلي، انفجار قدر له أن يسطر على الورق هكذا قوة الجمال في جملة غير محسوبة ولكنها مرغوبة ومرهوبة. وصرت أكثر انقيادا له وصار اردال منسحبا كليا فنهض ونادى على الزنبور فرفض حسن مطلق وأجاب بلهجة مسرحية
ـ لا، أنا سيد الجلسة ودافع خساراتها.
وطلبت مزيدا من البيرة من زنبور وطلبت منه خيارا ورحت انتبه إلى حسن وهو يحاول أن يدفع الحوار إلى الأدب. ثمة لحظات شعرت بها بأنه يعني تماماً ما يقول وأخرى، كنت أشعر به لا يجيد الكلام أو أنه بالأحرى يجد أن الكلام لا يعطي تغطية كافية، ما هو الأدب؟ كيف يمكن التخلص من المفهوم العام للأدب. سرعان ما أحس بالضيق من المكان. كان البار مكتظا والدخان يجر نفسه سحابات فوق رؤوسنا. كان يفكر بالحافات، نعم الحافات بكل شئ.. بالأدب، بالفكر، بالرؤية المباغتة المتقطعة ولكن المبنية جيداً
ـ الرؤية المصيرية للعالم.
ـ ماذا تعني بذلك؟
ـ الرؤية بمعنى السر
ـ أي سر
ضحك ثم قال
ـ السر في أن تكون أنت واردال لاصقين هنا في هذا المكان، هيا لنذهب إلى الأعلى.
ونادى على زنبور بصوت جهوري ومسرحي
ـ الحساب من فضلك.
(3)
مثل طلقة جنونية.. هكذا امتطى حسن مطلك سيارته البرازيلي الحمراء اللون منعطفاً على شارع أبي نؤاس متفادياً على سرعته الرهيبة أطفال الغسيل الذين يتصيدون وقوف السيارات لغسلها دون إذن من سائقيها، وسرعان ما دخل شارع فرعي ثم انعطف كما لو كان يدخل غرفة نومه الخاصة إلى جراج داخلي يبدو أنه اعتاد المكوث فيه، صفق بابه ونزل مسرعا وفتح جيب الصندوق الخلفي لسيارته الساخنة وأخرج حقيبة جلدية سوداء لامعة ثم أشار إلي بحركة من رأسه أن هيّا.
كان فندق ميريديان منار كلياً وزجاجه اللامع يبهر الأبصار، وكان هو يسير فاتحا ساقيه قليلاً يحرك حقيبته السوداء بنوع من الاستهتار والشجاعة بادية عليه. وقفنا بانتظار نزول المصعد غير عارف إلى أين نحن ذاهبين
ودخلنا إلى غرفته المربعة المرآتية وصعد بنا المصعد إلى آخر ما لديه من ارتفاع.. وقبل أن يتوقف المصعد لمحت إشارة حمراء مضيئة تخبرنا ببار (هلا)..
ـ هلا.. هل أتيته من قبل؟.
ـ لا.
ـ إذن هيا إلى هلا.
صالة علوية واسعة لكنها متمفصلة بعدة فواصل هي عبارة عن خانات صغيرة مقطعة مخصصة للعشاق الذين ينزوون هنا وهناك، ليليون وخائفون ومتوارون. سبقنا النادل الذي لم يكن زنبورياً بعد فهيئته تدل على ضخامة لا تتناسب مع زنبورية نادل بار الانتعاش وكان ركننا يطل على نهر دجلة والسحاب غير بعيد عنا وسرعان ما قال لي حسن مطلك:
ـ اسمع، أنا وأنت لابد أن نصبح أصدقاء.
ـ ومن قال عكس ذلك؟
فتنحنح ثم أضاف
ـ أنت تتوهم نفسك مختلفاً أو أنت تتصور بأنني لا أعرفك جيداً.
أردت أن أوضح له بأنني لم أكن أعني ما أقول له حقا وانه كان قد أجبرني على مناكدته ولكنني فضلت أن أصغي إليه. كان وجهه حزيناً بعض الشيء، لعله كان مجهداً قليلاً، فهو رجل غير كحولي وبذل جهداً واضحاً في العناية بأفكاره وكلماته. كان النادل الضخم ينتظر إشارتنا فقال لي حسن:
ـ أنا لا أحب الخمرة اطلب أنت.
فأجبته بلهجة مصطنعة:
ـ وأنا أيضا لا أشرب كثيراً.
ـ أنت!؟ لا تكذب، إن نهر دجلة في نظرك نهر من الخمرة.
مددت قدمي إلى الأمام وطلبت ويسكي بالصودا ثم سألته
ـ لماذا جلبت هذه الحقيبة.
ابتسم قليلا ثم ألقى نظرة إلى ما حوله ورفع الحقيبة ووضعها على ساقيه:
ـ هل تعرف أن تسمع من يقرأ لك؟
ـ طبعاً.
ـ إذن اسمع.
لا يجرؤ المرء مهما تغطرس أو تمترس إلا أن يصغي للجمال الباذخ الذي يكتب مهما كانت الظروف والأحوال. لم أكن قد استمعت من قبل إلى ما يجعلني أتضور جوعاً للمزيد. كانت هناك قصة، تلك التي استمعت إليها أو لعلها لفافة أولية لخطاطة ما لم أكن أصغي لما يكتب بل كنت اسمع ما يجب أن يقرا، كانت الصور سريعة منغمة ومفلوته عن سياقاتها وكان هناك خالق أمامي يمرغني بالجنون والرفعة والأرض تفلت من تحت قدميه وهو ماسك بزمام الكلام عارفا أين هي الوقفات والسكنات التي هو بحاجة إليها.. وصرت أتمثل الرؤية المكتوبة ببطء أو لعلني كنت أتلمس اللغة في فيضها السردي ودقة الشحن الشاعري المولد عنها وصرت أعب كؤوس الخمرة غير لامس من المزمزات شيئاً، أريد أن أشرب من أذني وفمي غير مستعين بأسناني المهترئة.
إنها لحظة هاربة من معطف التاريخ، نوعا من الجنون المرهوب، لكن المرغوب والنادر صار الوقت منفتحاً على اللانهائي وكنت للتو اكتشف عبقرية وأرى في ملامح وجه هذا الفنان انسرابا جديدا لأدبنا المتواضع الموروث والمصنوع والمرتشي بالآداب العالمية الجاهزة.. كانت له طينته الخاصة في الكتابة، له حماقات وخروقات غير مستساغة، ومع ذلك كنت ما زلت في حيرة معه، من أين له هذه الطريقة في الكتابة، ولماذا لم أكن أعرفه من قبل؟.
وكان النادل قد اترع كأسي أكثر من مرة وصرت في عالم آخر تعذر على أن اركز معه بل كنت بحاجة إلى ابتهاج آخر معه. هبطنا من (هلا) مترنحين وأخرجنا السيارة منطلقين في شوارع بغداد. كان يرغب بإيصالي واكتشاف المكان الذي أهبط فيه كل يوم. لا ادري كيف عرفت طريقي. كان الليل موحشا إلا أن بغداد ما زالت تولي الليل بعض ثقتها. وصر الباب الحديدي في يدي وصعدت السلم الحجري لمنزلنا الشعبي المنبوذ في (حي الكمالية) وبادرني شيخ الجامع بأنه لا زال ساهراً وقال لي بسماعته العالية الصارخة:
ـ الله أكبر الله أكبر.
وكانت وسادتي في انتظاري منذ زمن طويل ومازالت أحلامي نفسها تطقطق أصابعها هناك وتشرب جنوني الفتي الذي ما زال بحاجة إلى سقف منزلي وقليل من الجدران للمكوث فيها.
(4)
توهمت سميرة بان ذلك هو أنا فدبت على ساقيه ببراءة الأطفال وندت منه صرخة عالية زرعت الرعب في أعماقي وجددت الصحو في ذهني في ظهيرة اليوم التالي، واكتشفت أن حسن مطلك، هنا في غرفتي العلوية الكائنة على السطح. كان جالسا شابكا قدميه تحت فخذيه يرتدي ملابسه كاملة باستثناء جاكتته المعلقة على كتف كرسي طاولة القراءة ودهشت لهذا:
ـ هل أتينا معا؟
ـ نعم.
قال حسن ذلك ثم انبطح على بطنه وزحف باحثاً عن سميرة، وقلت له:
ـ إنها مجرد فأرة.
ـ طبعاً فأرة وهل كان ذلك ديناصوراً!
لقد ربيتها بعد أن ارتكبت ذنب قتل أمها هنا ذات يوم، كانت صغيرة وعمياء، أطعمتها وأعطيتها الأمان ثم أصبحت صديقتي، إنها سميرة، الفأرة سميرة.
نهض حسن وألقى نظرة عريضة على رفوف مكتبتي التي تغزو الجدران، كتب في كل مكان، كتب تنام تحت بعضها البعض، كتب على السقف كذلك. كنت قد علقت شبكة بلاستيكية من النوع الذي يستخدم في مرمى كرة القدم على طول السقف ووضعت كتب في باطنها، وكان ذلك كفيلاً بإعطاء صورة لكهف كتبي لا شك فيه.
ـ سميرة وعَرَفانها، ما هي حكاية هذه الجمجمة؟
جلبت لنا (علياء) شقيقتي صينية كبيرة، عامرة بقيمر المعدان ومثلثات جبن وأرغفة ساخنة وإبريق شاي، وكان الشاي هو كل نصيبي بينما أجهز حسن مطلك على كل شيء. كانت الجمجمة تعود إلى متحف مدرسة الإعدادية النظامية التي يعمل والدي حارساً وفرّاشاً فيها، هكذا كانت جمجمة للدرس موضوعة في متحفها الخاص عندما دغدغتني شهوة السرقة عندي ورغبتي لاقتنائها بأن أجلبها هنا وأعطيها سلطة الآمر والناهي في مملكة الكتب هذه. كان حسن مطلك يصغي إليّ بارتياب وهو يرسل نظرات متقطعة إلى سعادة الجمجمة الضاحكة بين آونة وأخرى، وطلب أن أتركه مع الكتب قليلاً ثم وقع اختياره على كتاب (أسطورة سيزيف) لكامو. وكانت نسختي المفضلة، فالتقطه بعناية ثم قال: لدي رغبة بأن نقضي بعض النهار معاً. لأنه كان لابد أن يعود إلى الشرقاط نهاية ذلك اليوم.
صرختُ به:
ـ دير بالك!
ـ ماذا؟!
كانت سميرة تتشمم حافات حذاءه وصار أكثر رقة فانحنى عليها وأراد التقاطها فلم تمانع وزحفت على كفه ونامت بين أصابعه. قلت له:
ـ مازالت عمياء.
فأجاب:
ـ لقد أنسنتها، فماذا تنتظر..
وأعاد سميرة إلى الأرض ونظر بتفحص إلى جمجمتي الأثيرة وصار أكثر قناعة بجنوني الخاص مذ ذلك الحين.
********** **********
مقهى البرازيلة فاترة بعض الشيء، لم يكن حسن العاني موجوداً ولم تظهر آثار رحيم يوسف بعد، إلا أن حسن مطلك كان مصدعا بعض الشيء، تركني بحثاً عن صيدلية قريبة وجلست أفكر بما جرى لي من أحداث متعاقبة وكنت في وعثاء السكر بعد، محمر العينين ومنفوش الشعر. كان من المفروض أن أذهب إلى الكلية، فأنا لم أسجل بعد حضوري فيها.. وطال زمن غياب حسن مطلك، زمن أكثر مما تستحقه صيدلية قريبة، وصرت قلقاً عليه وقررت أن أذهب للبحث عنه ورمقني أبو مهيدي بنظرة متشككة لولا أن حقيبتي الصغيرة المتروكة على الطاولة ضمنت له عودتي لدفع حساب القهوة الحلوة التي شربت منها اثنين.
كانت سيارة حسن مطلك غير موجودة في مكانها، كان قد صفها قرب رصيف المقهى المقابل وهذا يعني بأنه لم يذهب مشياً على قدميه، وصار مفروغاً منه بأن أمرا ما كان قد حدث.
ولم يحدث شئ، عدت خائباً كما لو أنى خارجا من حلم وأنا أفكر بما عليّ أن أفعله للسؤال عنه. لم أسجل تلفونه حتى، إلا أن شعورا ما كان يخبرني بأنني حصلت على ذات مبدعة ولعلني لم أكن حينها قد قرأته بعناية، لم يترك بين يدي أثرا كتابياً له، جلست منتظراً قدوم شبحه الخاص وتذكرت ابتسامته ونظرات عينيه وقدراته الكلامية. كان ذلك كله يشي بأسلوبه الخاص وطعم شخصيته، ولكن ما الذي دفعه لان يتركني موشوشاً هكذا؟.. أين تراه ذهب؟.. ولماذا لم يكلف نفسه عناء إخباري بما ذهب إليه؟.
صار الوقت بطيئا حتى وأنا أشاهد رحيم يوسف وشخص آخر يدعى راضي داخلان إلى المقهى. كان رحيم يستند على كتف راضي ويمشي بصعوبة، جلس رحيم إلى طاولتي بينما تفاداني راضي وذهب ليجلس بمفرده. كان مثقفا حساساً لا يطيق الحوار معي ودائم الإدمان على التهم الشخصية والمهاترات، ذلك أنه كان يرى نفسه أكثر أهمية.. ولكن لا أعرف مِن مَن؟.
صار الوقت الطويل يقينا لا شك فيه بأن حسن مطلك لن يعود، ولمس رحيم يوسف قلقي وطمئنني بأنه اليوم على ما يرام ماديا وأننا معزومين بالقصر الفضي على حساب ماجد جبر، وعليت صوتي لأُسمع راضي الغير راضي بأننا اليوم خمر وغداً أمر، وضربنا وجهتنا صوب الجانب الآخر من (ساحة التحرير) إلى رصيف المكتبات كان ماجد جبر يعمل هناك كتبي في مكتبة التحرير وكان شابا أسمر دقيق الملامح صموت جداً ما يكفي لان يصبح بعد سنة من هذا اللقاء مجرد جثة لا حراك فيها مهشمة ومشوهة وملقاة على أكتاف الساتر الأمامي للحرب العراقية الإيرانية التي كانت مازالت دائرة إلا انه كان بطيئا في العمل واضطررنا إلى انتظاره أكثر من ساعة ونصفها وانضم إلينا باسم حردان وهو صديق مقرب جدا لماجد جبر يشبهني في نحافته إلا أنه كان يزرر عينيه دائما ويمتص سيجارته بنهم وتوسل كما لو كانت كأسا من العصير. وانتهينا في القصر الفضي من أعمال بارات أبي نؤاس. وكنت ما زلت أرغب بان أبحث عن حسن مطلك أو في القليل أن أذهب إلى بار سميرا ميس المجاور للسينما سميرا ميس لعلني أعثر على أردال، واستأذنت من أصحابي باني لن أغيب طويلاً، وكان حدسي الكحولي في محله. كان اردال هناك وسط فوضى الزبائن وضجيج التلفاز، ينتحي ركناً جانبيا قرب الزجاج المطلي بالأحمر العتيق وجلست من فوري وقابلني اردال ببرود مألوف فيه ثم قال لي:
ـ هل تجرب الجعة؟.
كان يحب أن يقول للبيرة (الجعة) وهززت رأسي موافقاً بالرغم من أني كنت قد صفيت حسابي مع ربع عرق زحلاوي قبل قليل وأن الخبط سوف يتعبني وكنت أهم بأن أساله عن حسن مطلك إلا أنه بادر وقال لي:
ـ حسن يُسلم عليك.
ـ هل رايته؟
ـ لا، لكنه اتصل بي وقال لقد اضطر للذهاب إلى الشرقاط تلك الليلة.
ـ آه، هكذا إذن؟
وصار الجو أكثر رتابة، ولم يحضر الموضوع المناسب بعد. كان اردال يجري حسابات مزعجة لا أعرفها في دفتر صغير ثم انتهى أو لعله قاطع نفسه وقال لي:
ـ لم تكن فرصة سعيدة لقاءك مع حسن؟
وأيقنت بأن اردال كان يظن بأننا انتهينا على خلاف وان أمور سيئة حدثت بيننا، فضحكت ثم ارتشفت كأساً مترعاً من (الجعة) ورحت أطلق العنان للساني بأن يقول ما يشاء. كان لابد لي أن أقول أن الصورة التي لدي عن حسن لم تتضح بعد وأن على اردال أن يساعدني قليلاً بمعرفة المزيد عنه ولعل الجانب الغائبي من شخصيته لم يكن هو الأهم، عموماً لقنني اردال درساً طويلاً عن ما يشبه الكلام عن حسن مطلك. لم يكن دقيقاً كفاية وكان يتحدث عنه كما لو كان إنساناً فوق الطبيعي وأدركت بأن اردال يعرف أكثر مما قاله لي أو لعله لم يرغب أن يغادر نرجسيته قليلا أو ظن بأن لقاءنا أنا وحسن لن يتكرر. وكان ذلك كلاماً على أية حال لم يكن هو جوهر الموضوع بالنسبة لي، أصبح اردال أكثر تشددا معي وقال لي بأن حسن لا يصلح لأن يكون صديقاً معرفياً وسوف لن تراه مجدداً وغيرها من الكلمات التي تشبه الأحاجي والألغاز. كان اردال مهووساً بالصوفية لذاتها بمعنى كونها خطابا أدبيا ليس إلا، مزاولة أسلوبية، طريقة في التعبير، كلام جميل بلا اله ولا بطيخ.. هو ماض في ترتيب نفسه على هيئة أسرار، حفنة من أسرار الكلام، تكتم دائم وتحسس من البوح وله نوع من حذره المرضي من أزلام النظام البوليسي ويشعر بان الدكتاتور يعرف ويرى ويسمع كل شئ حتى الضرطة في المرحاض.
وسمعنا قرقعة مجاورة ثم ارتطام وانقلاب طاولتين وتكسر عدد من قناني البيرة، وهربنا من شجار دموي وشيك وابتعدنا عن الحانة دون أن ندفع حسابنا. وعرض علي اردال أن يوصلني بسيارته اللا ندروفر التي خصصتها الشركة له.
ولكنني ما زلت أرغب بالخمرة وما زال الليل طويلاً ففارقته ومشيت سريعاً صاعدا على جادة أبي نؤاس ولم يكن البار بعيدا وسمعت مصب بول أحد السكارى على جدار البار الخارجي ودخلت مترنحا قليلا وكان المكان اكثر سعة من بار سميرا ميس. ووجدت رحيم يوسف مشتبكاً بحوار ساخن عن القصائد الأخيرة لسعدي يوسف هي قصائد أقل صمتا وأشركني بالنقاش من فوري، وصرت أقول كلاماً جميلاً لا أتذكره عن الشعر والشعراء الآن. النادل كان يلح على الحساب وباسم حردان شبه نائم والجو مشحونا وماجد جبر ذهب كعادته إلى المنزل مبكرا ليعد نفسه للموت في الجندية وصار نهاية الجلسة مربكا بالنسبة لي وكنت بحاجة ماسة لأن أرى حسن مطلك من جديد فلدي كلاما كثيرا أريد أن أقوله له.. وسوف أقوله.
(5)
سوف أقول كلاما آخر لا يشبه ما بلغته به يومذاك، كلاما أو إعجابا. كنت قد سجلت اسمي في دفاتر الجامعة في قسم المسرح مع أني واثق بان سرة بطني مدفونة في كلية الآداب، قسم الفلسفة وفي المركز البريطاني في الوزيرية. جلست بصحبة فنجان كبير من النسكافيه مع كتاب (مائة عام من العزلة) لماركيز. وكنت بانتظار فتاة كردية هي طالبة في كلية طب الأسنان، عندها لمحت حسن مطلك داخلا وكان يمشي إلى أمامه غير ملتفت لأحد وسرعان ما وثبت عليه وصافحته بحرارة وقدته من يدي إلى حيث أجلس، وكانت الشمس تسرح في الحديقة الخلفية للمركز البريطاني نساء حليبيات اللون لهن شعور شقراء يزرعن ديكورا إنكليزا مناسباً. كان حسن مطلك عجولاً في جلسته ولم يخبرني بسر قدومه إلى هنا، تطلع إلى ساعته وقال:
ـ أنا غير موجود هنا بعد.
ـ لم أفهم
ـ سوف أرحل الآن، وسوف نلتقي في المساء.
وكان ذلك هو ما يسمى عادة بلقاء عابر. سرعان ما ابتلعه الغياب من جديد ووصلت فتاتي الكردية ودخلت متمهلة تحمل مريلتها البيضاء على ذراعها، وكنت أفكر أن أذهب إلى المساء السعيد القادم، وكان اردال هناك لمحته يمشي أمام نصب الحرية وكنت مازلت أتصفح بعيني الكنوز الرائعة في محل الجقمقجي وصور نادرة بالأسود والأبيض لعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش وناظم الغزالي وأم كلثوم عندما خرجت باتجاه اردال وناديت عليه فلم يسمعني. كان قد دخل إلى بار الانتعاش وعرفت أنه على دراية بموعدي مع حسن مطلك، وجلسنا بعض الوقت. كان اردال مهتما بأفكاري عن حسن مطلك وصار بمقدوري أن أخبره ما أشاء عنه، ولكني كنت حريصاً على أن أقول ما أعتقد وأن لا أجازف وألقي كلامي على هواه. وكان اردال قد طلب القليل من الجعة من زنبور الذي ادعى بان هناك نقص في حساب ذلك المساء وكنت ابتسم لأردال مكذباً ما ادعاه زنبور متصورا ثمالتنا ونسيانا المستحيل..
ولم يكن حسن مطلك قد لاح لنا بعد. كنت أظن أن اردال يعرف خطواته الإبداعية جيداً إلا أن ما دار بيننا من كلام كان يتضح من خلاله بأنه معولا عليّ في فك طلسمه إن كان هناك طلسم، ان الأمر كان يأخذ عند اردال حجماً أكبر، هو هكذا دائماً وسواساً بعض الشيء وغير واثق مما يدور حوله ولم يكن حسن متبعا لخطوات كتابية متراتبة.. هو انبجس في سماء كتابتنا مثل ماء من تحت تبن وكان التبن غزيراً والماء مهم وشحيح.
ـ السلام عليكم.
وكان ذلك هو حسن مطلك، رمقته بنظرة معاتبة على غيابه المفاجئ عني في ذلك النهار، وقال هو كلاماً غامضاً عن ركضة الأمكنة، وقدراتها على حمل الماشي عليها وقذفه إلى البعيد كان متفائلاً ومبتسماً كعادته وقال مخاطبني:
ـ جلبت لك قصة قصيرة جديدة.
وكانت تلك هي (إشارات قبائل القاعة) أو مسودتها الأولية.. لست أذكر.
وكنت مهتما فيما يكتبه وعازما على قراءته جيدا، حينها خوضنا بأفكاري عن الفلسفة وما كنت أروج له من نظم الاشكالويات وهو انهمام معرفي وابستمولوجي أكثر منه عملاً فلسفياً مستقلاً أو تخصصي. كنت أضع المعرفة إلى جانب الإشكال أو بمعنى أدق كنت أرى أن الوعي هو وعي المشكلات ولكن الفهم هو تمثل الإشكالي وإعادة تأسيسه وهو حقل كان بعيداً عن اهتمامات العقل الأكاديمي العراقي آنذاك. ولعل ما كنت أسعى إليه هو ضبط لاتجاه فلسفي هو التخلص من مفهوم (الحقيقة) و(الواقع) وإعطاء الفلسفة فرصة إبداعية أكبر، وكنت للتو قد بدأت الطريق في الكتابة في جريدة عسكرية هي (القادسية) وكنت أنشر أيضا في صحف غيرها وكانت المزحة الغالبة على كتاباتي هي أنها صالحة للنشر لأنها غير مفهومة.
والأمر عند حسن مطلك هو كونه كان يؤسس بدراية الأفعى وصبر اللقلق وعناد دودة ما سيطرح ثماره بعد حين، في (دابادا) و(قوة الضحك في أورا)، انه لا يؤمن كما كنت أرى بالبدايات أو المكونات العلمية المصاحبة لمهنة الأدب، هو موفور الصحة من ناحية اللغة ولم يكن ينقصه الشعر إلا انه دائما لا يعطي ثقة كافية للفهم أو الشرح وكان كأسه اليتيم يبقيه صاحياً حتى الثمالة. كنت قد أوليت عناية أخلاقية لحضور أردال وهو آخر الشياطين العتاة الذي كان وما زال مصيره مجهول لولا أن حسن مطلك قد أفتى، وبلا تردد، ببؤس السردية العراقية وانتفاء الحاجة إليها، كان يتكلم عن زيف ما، عن خدعة جمعية وعن تقليد القصّر للأكبر منهم سناً.
ـ وماذا عن الشعر؟
قال اردال
ـ أما عن هذا، فحدث ولا حرج.
وراح يروي لنا كيف أن الشعر العراقي يكاد أن يكون كله شعراً!
ـ ومع ذلك أريد أن أفهم؟
قال اردال.
ـ وليكن، إن شِعراً يتناسل هو عبارة عن امرأة واحدة، وامرأة واحدة لا تكفي لحفلة، طبعاً أنا أقول ذلك بحثاً عن العمق داخل اللغة، أين هو الكلام الشعري الذي لا يشبه اللغة، قل لي يا أردال، أين؟.
وكنت أفهم ما يقوله، أقسم بأنني كنت أشعر بذلك النوع من التصحر المتكثر، كان ذلك إعطاء اللغة دور الشِعر، بينما هو، أي الشعر، هو انزياحها، عدم كفايتها المنطقية، ثوريتها بلا قيادة ولعله لم يستقي ذلك من مصدرية مركزية أو مرجعية تاريخية، إن إخفاق التأثير يعرف ما هو الأدب؟
ـ وما هو الأدب؟
ـ اسأل أخ القحبة سارتر.
وضحكنا، وطلبنا من زنبور (جعة) جديدة. وكانت بغداد ترش مطرها وتعتصر غيماتها في الأعالي ونشاهد المارة يتقافزون والسيارات تطلق زماراتها ونحن نحتسي بيرة المساء لاهين عن الحرب التي تحدث في البعيد وتقتل البعيد كله وتمزق أشلاء القريب من الناس وتضحك على عقولهم وتعدهم توابيت محققة.
وكنت أرى أن البيرة سيئة، وأن العرق سلاحنا الأبيض في مواجهة المهزلة أو المأساة في معطف مهزلة، لا فرق. وكان اردال يتذكر مقاطع قصيدة جديدة له، كنا نحبها أنا وحسن، خاصة مقطعها المحبب (في زنبور الشهوة.......) وكان اردال يحب صوفيته الشعرية ويبارك تجارب (أدونيس) و(أنسي الحاج) وكان الليل يزحف في أعناق الزجاجات القاتمة اللون وحسن يرفض أن يقرا لنا شيئاً من قصصه أو مسروداته بينما يحرص أردال المهندس أن ينضبط في ذهابه المبكر من زمن البار المتأخر ويدفع نصف ما علينا تاركاً النصف الآخر إلى حسن مطلك، فلم أصل أنا بعد إلى سن الدفع.
واقترح عليّ حسن أن نتحسس بغداد بأقدامنا فخرجنا من (الانتعاش) وكنت أكثر رغبة في الشرب في مكان آخر، إلا أن حسن مشى أمامي صوب الجانب الآخر من شارع السعدون. كنا نغتسل بمطر خفيف لكنه بارد بعض الشيء، وعرفت من وجهته بأنه ذاهب إلى (البتاوين) فتبعته وكان هو يمشي بصمت ويتطلع إلى أكداس من المصريين في المربعة، وصار المكان لزجاً ومجاري المياه مفتوحة فيه، ولكنه لم يبالي كان شعر رأسه قد تبلل بالكامل وأخذ أنفه يقطر مطراً، وعرفت أنه يمشي وحيداً، وسرعان ما راوحت بقدمي وتركته يبتعد في زقاق جانبي.. وكانت خطواته تغطس في برك الماء الآسنة وهو يمشي بعناد طفل ربما أو لعله لم يكن يعرف بأنه يمشي، وتوقفت ناظراً إليه من بعيد وكأنني كنت أعتاد غيابه، واشرف على ذهابه للمجهول.. عادة ذلك الذهاب كله الذي كانه وأراده وعمل من أجله.. كان العالم ضيقاً عليه ومن كان مثله لا ينتظر موته، بل يصنعه ويتعب عليه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*عن موقع (أدب وفن) بتاريخ 21/1/2007م.
*خضير ميري: كاتب عراقي. Khdhrmery@yahoo.com







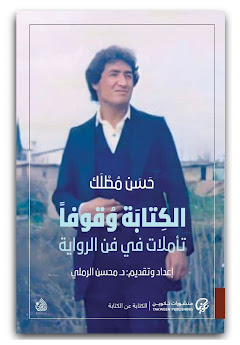


















ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق