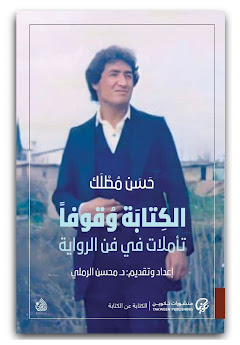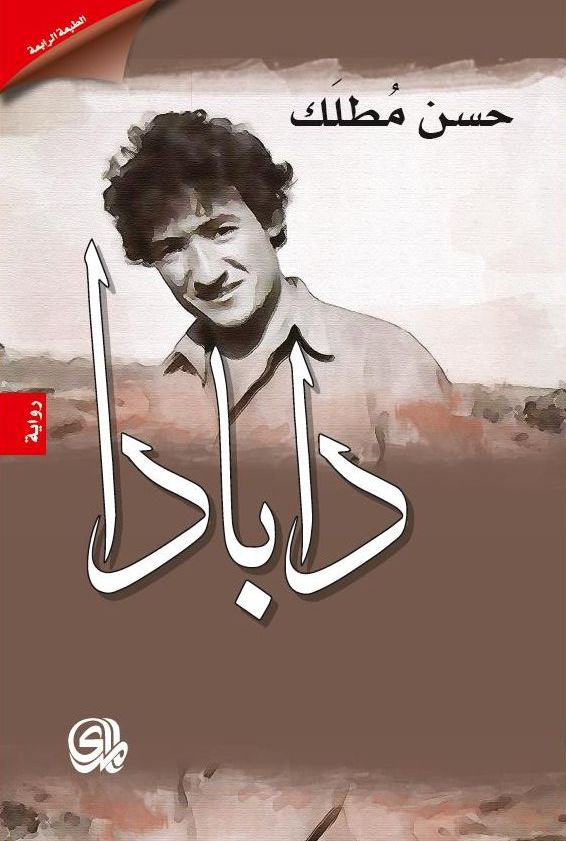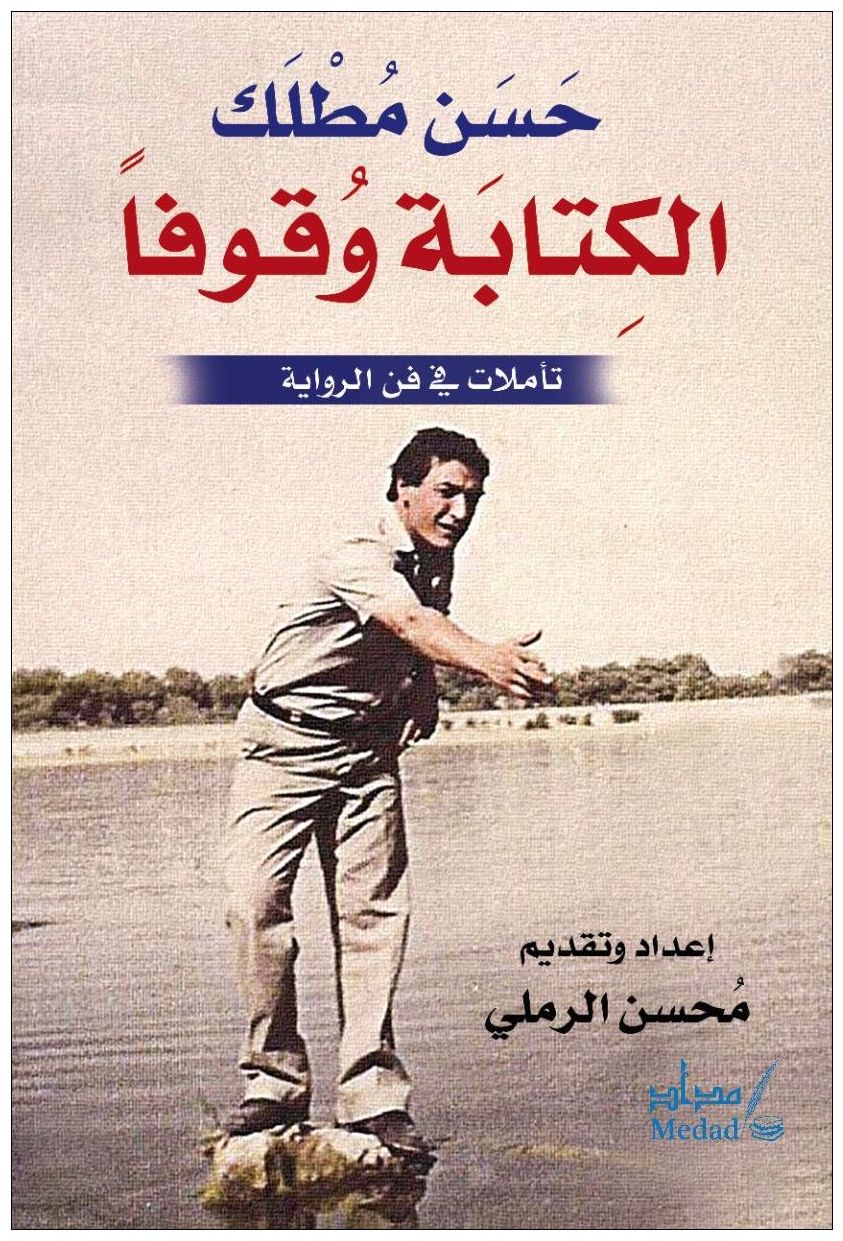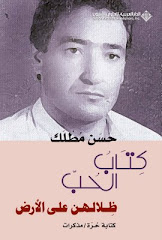شـهـادة جـمالـية عـن الـحرب
حسن مطلك
فَرضَت عليّ الحرب تجربة، ومن هذه التجربة
حصلتُ لنفسي على مقدمة منطقية كبرى: إن كل ما يخاطب النفس فهو مقنِع. أصبحت هذه
المقدمة منهجاً لجميع كتاباتي في هذا المجال. لقد اكتشفت خصوصية الكتابة عن الحرب،
أو ما يسمى بأدب الحرب لغرض الدراسة والنقد. لأن الكتابة عن الحرب لا تختلف عن أي
نوع آخر من الكتابة، غير أن هناك خصوصية معينة، كما قلنا، لهذا النوع، فحظ الخيال
أقل، وكلمات العزاء أقل فاعلية وتأثيراً من الفعل، فلا قيمة للعزاء إذا لم يقدم
على شكل فعل: أن تعمق معي خندق القتال أفضل من أن تقول لي: اصبر. وكان عليّ أن
أنقل الفعل نفسه في القصة أو الرواية خالياً من كل كلمة مفتعلة، خالياً من كل تطلع
آمل.
فقد كانت هناك
فكرة سائدة عن أدب الحرب: أن يحمل النص قذارة الحرب نفسها. ولكن تجربة الليلة
الأولى في الجبهة علمتني، فيما بعد، أن أواجه الحالة الدموية بنص رقيق، وأن الجانب
الشعري والجمالي يجب أن يحتفظ ببعض الهدوء والكبرياء. ألتمس منكم أن تسترخوا في
مقاعدكم الآن، لأنني لن أُسمعكم صوت انفجار قنبلة، فهذا الأمر لن تتصوروه أبداً..
فأطلب منكم الانتباه إلى الجملة الأولى في آخر قصة كتبتها عن الحرب، اسمها (بطل
في المحاق) :" في إحدى الأمسيات من زمن الحرب، طارت شظية مسننة فنبتَت في
ظهر خالد وهو يضحك بكل قوة، لكن الابتسامة لم تسقط عن وجهه فجأة، بل انسحبت بتمهلٍ
لتحل محلها صورة الألم.. وكأنه حُقن بالحِبر..". وهناك في موضع آخر من شوط
التجربة الطويل تأكد لي أن القليل من الجد لا يكفي لإنشاء قصة تصعد إلى مستوى
الحدث ذاته، فليس هناك حدٌ أدنى للكتابة عن الحرب، لأن ليس هناك حدٌ أدنى للموت.
أعني ملامسة النار باليد والروح وهو الاختيار الوحيد الممكن لتقدير درجة حرارتها.
لقد لامستها بيديّ هاتين، حتى لقد كان من السهل أن أفقد يدي التي أكتب بها، وكان
هذا يرعبني أكثر مما لو أني متُ فعلاً.
لو حدثتكم عن
جميع مشاهداتي، رغم قصر المدة التي قضيتها في الجبهة، والتي لا تتجاوز بضعة شهور،
دخلت فيها معركتين، إذن لاحتجت إلى حزمة أوراق، ولاحتجنا إلى وقت لنسمع.. وربما
نـحتاج إلى أكثر من وقـفة لـنتأمل.
ولنقف هنا عند
تجربة صغيرة: خرجت مرة بصحبة دورية قتالية في الأرض الحرام، ليلاً طبعاً، كان ذلك
في أرض الجنوب المنبسطة، وكان الرصاص المعادي ينفذ من بيننا كسنارة الحياكة، وحدث
أن سكنَت الجبهة بقية الليل، وبعد ما نفذنا الواجب ـ فقد كان لها فترات من الصمت
أشد هولاً من لحظات الاصطدام ذاتها ـ كنا نمشي طوال ليل حالك.. نمشي ونمشي ونمشي..
فاعتقدت بأن رغبتنا بالعودة إلى مواقعنا، قد صورت لنا الطريق أطول مما هو عليه في
الواقع.. وهكذا، حتى بدايات الفجر الأولى، حيث اكتشفنا أننا كنا ندور في دائرة صغيرة
من الأرض. وكان لهذا الدوران أكثر من معنى لديّ؛ ففي قوانا اللاواعية كنا نحمي
أنفسنا دون أن نعرف، إذ أن الخوف من المتوقَّع.. الخوف الذي لم نتمكن أن نعلنه
لبعضنا مخافة المزيد من الخوف، جعلنا نشعر أننا محاطون بالموت أينما اتجهنا. وفسرت
تاريخ الحروب كلها على أساس هذا الدوران. وتعلمت أشياء كثيرة في هذه التجربة؛
عرفت، مثلاً، أهمية المكان بالنسبة لأي حدث، وأهمية أن يكون المكان معروفاً لأجل
الألفة، فليس هناك شيء يفوق المكان في الأهمية بالنسبة للجندي، وبالنسبة للقاص
والروائي والمسرحي.. فطوال تلك الفترة، وفي لحظات الحاجة إلى الأمن، كنت أحمل في
داخلي صورة لبيتي القروي أينما ذهبت، فمعرفة المكان معرفة مباشرة تكفي لإنشاء قصة
صادقة. وثمة دلالات أخرى للحدث تستطيعون تصورها.
ظلت الحرب معي
حتى بعد أن غادرتُ الجبهة، وهي معي الآن وغداً وبعد غد، في تجربتي وتجربة الآخرين.
في تجربة (حسين عبدالقادر) مثلاً: الذي أُصيب بشظية صغيرة استقرت في عظم الحوض.
فهو في كل محاولة لكي يلامس زوجته يكاد يموت على طرف السرير، في ذروة لقائه الجسدي
بها.. لحظة الإضاءة الجسدية. كانت هي تستمتع، بينما كان يتألم بأشد ما يكون الألم،
فلم يكن يريد أن يطلعها على ألمه مخافة أن تفقد سعادتها ولذتها به.. ذلك أنه كان
يحبها جداً، فعليه أن يخفي ويحتمل.. يخفي حتى بكاءه. وهذه الحادثة وحدها يمكن أن
تلخص الحرب كلها... قلت سأكتب عنه لتحديد هذا الانكسار، ففي معركة الفاو كانت طلقة
مارقة قد خرقت زمزميته وهو يهم أن يـروي عـطشه.
لقد لاح لي
الأمر أحياناً؛ أن الكتابة إزاء مثل هذا الألم مجرد لعبة، وشككت أحياناً في
إمكانية أن أكون وفياً لأخوتي هؤلاء... إن حسين عبدالقادر قد حمل الحرب بداخله حتى
يومه الأخير.. ألسنا بحاجة إلى أكثر من وقفة هنا؟. وأكثر من تأمل؟.. ألم تكن هذه
التجربة الفريدة أقوى من أصوات المدافع مجتمعة؟.
في بداية الحرب
كان لدينا الكثير من المبررات للحلم بخوض هذه التجربة، بسبب قراءاتنا السابقة عن
أدب الحرب في العالم، حين دخلناها فعلاً، وبكل أبعادها وحرارتها، أصبحت مبرراتها
أقل. فقد تحولت الأسئلة إلى غصة. ذلك أن الأسئلة الكبرى تُصنع في أوقات الفراغ.
أما في الحرب، فثمة ذهول يعتم كل إجابة. فلماذا لم تحظ الحرب بكفايتها من التنظير؟
ولماذا استُبعِدت من مشاريع أغلب الفلاسفة؟ مع أن معظم شعوب الأرض قد خاضت هذه
التجربة وستخوضها في يوم ما.. فهل هذا يعني أن التساؤلات الكبرى لا تأتي إلا من
أوقات الفراغ فعلاً؟.
إنني أفتح هذا
الباب لكم، ومن خلال تجربتي الصغيرة، وتجربة بلدي، أن تدخلوا وتفتحوا ملفاً للحرب،
إلى جانب ملفات الديمومة والكينونة والانطولوجيا.. والوجود في ذاته، وفي ملفات
الكتابة والنقد الأدبيين إلى جانب الحبكة والأسلوب والمضمون والثيمة والسوريالية،
وليبتدئ المفهوم الدقيق لأدب وفكرة الحرب من هنا والآن.
وبعد ذلك، فإن
القصة التي كتبتها والتي أحلم بها لم تتحقق بعد بحيث تكون بمستوى التجربة، لأن
الحرب لم تنته بالمعنى الفعلي بعد، فقد نبتت في داخلنا، كما قلت... إذن فالقصة
التي أحلم بها تجعلك تتلمس المكان حولك بحثاً عن سلاح أو ملجأ تختبئ فيه.
هناك شيء آخر عرفته من خلال تجربة الحرب؛ عرفت بأننا لسنا جادين أبداً، لا
في كتاباتنا ولا في قراءاتنا، ذلك أن ما كتبناه وما قلناه لا يساوي جزءً يسيراً من
هذا الألم الهائل: ألم الصدمة المميتة المُعرية.. صدمة الحرب.. وجهاً لوجه أمام
الموت." وكل مواجهة حقيقية للموت هي وجود أصيل" كما سماه (هيدجر). وبعد
التجربة بدأت أقرأ وأكتب بجنون.. أكتب، لا لكي أحمي نفسي فحسب، ولا لكي يلمع اسمي
أكثر.. بل لكي أكون أكبر من مؤامرات العالم كلها، أكبر من العالم نفسه.. ولأصنع
لنفسي معنى يتجاوز كل ألم وانسحاق، لأكون بمستوى الحرب من حيث الفعل.. وإلا فإنها
ستبقى أكبر مني.
-------------------------------------------------
*مداخلة قرأها حسن
مطلك في ملتقى عن أدب الحرب، ونشرت هذه الشهادة في كتاب (ذاكرة الغد) دار
الشؤون الثقافية/بغداد1989. وفي كتاب (الأعمال القصصية) لحسن مطلك، الصادر
عن الدار العربية للعلوم، سنة 2009م.