
قصة
تلك البلاد
نعيم شريف
قصة قصيرة مهداة إلى الكاتبين الشهيدين محمود جنداري وحسن مطلك
في تبويب الألم
ولذلك كله، فقد تساءل عن ماهية القسوة. وعما إذا كان الجمال المجرد له ضرب معين من القسوة يماثل تلك القسوة الخالصة التي تجيء من طريق الظلم أو الألم، أو تلك التي تجيء من الحنين كذلك. قسوة تظل مع ذلك أبدية. ثم فكر إنه العري.
عري الكائنات في الضوء، أو عريها في الذكرى. نوع من الوخز الحاد يرافق عادة التجرد الذي يحضر من الزمن المنصرم. التجرد الشبيه بمرأى صفحة النهر في مطلع الفجر، تلك البرهة التي ينسل فيها الضوء الأبيض النقي من بين أصابع الظلمة. فكّر: إنه الفرات. الفرات بلا اغطية ولا ثياب يتمدد عاريا. النهر وهو يغفو، تتقافز أسماكه الفضية على صفحة مائه الصقيلة.
هل ينطوي ذلك على منزلة من القسوة هي عينها التي يسببها إنعكاس الضوء المنسرب عبر فتحة السقف الزجاجية لحمام "أروات لار بغتات" على أجساد البنات السابحات في البركة الرخامية، العذراوات يضربن الماء بأكفهن فيَتطاير رذاذه عليهن، أم إن ذلك أقل قسوة؟
الضوء المنهمر الان من فتحة في سماء السنين البعيدة، مظهراً الأجساد البلورية ملتفة بالبخار يحيطها بغلالة شفيفة من نسيج متقطر. الأجساد الفتية للجميلات في يومهن من الإسبوع "يوم البنات"، لهن فقط عذارى المدينة. يجئن للإستحمام والمرح، صاخبة دماؤهن الحارة في أجسادهن الواعدة البتول، مستغرقات بخلود اللحظة المنفلتة من الزمن الرَتيب، تسطع ألوان عيونهن بالوهج.
سيرى إليهن في المدى الفضي للأبخرة المتصاعدة من قاع الحمام كما لو كن إوزات يسبحن في بركة من ضباب، تتكاثف الغلالة البيضاء في فضاء النسوة ذاك، فتغيب أجسادهن أو تكاد، ثم تتكشف عن حضورهن البهي، جالسات أو مستلقيات على المرمر الحليبي البريق، عروقه الخيطية باهتة وممتدة، لكنها حية ترضع الضؤ من أماكن سرية وحميمة.
يرشقن بعضهن البعض بدلاء الماء، يغرفن من أحواض صغيرة موزعة على محيط الحمام، ملقيات بأسماعهن صوب الصوت المتكسر لزهور حسين يقطع صالة الاستقبال، قادماً الى عمق الحمام، نحيلاً وحزيناً ببحته المجروحة، سائلاً عن إم عيون حراقة، فتردد الفتيات السؤال معها.
يغنين بلوعة، يضعن الانية على دكة المرمر ويبدأن بتصفيق موقع مرددات اللازمة كما لو كن كورساً للإنشاد، بينما تغيب روح الفتى ذو السنوات التسع محلقة في فضاء رحيب، الفتى الذي لايقوى على تمثل هذا الجمال الصافي لوحده، كان ثمّة قسوة خالصة في كل ذاك، ثمة سعادة لا تحتمل، جمال لايدركه الصغير، وهو يحدق محتاراً في عيني الفتاة التي أمامه، الفتاة الجالسة بهيبة على مصطبة المرمر والتي كانت تنظر إليه نظرات صافية، ومع ذلك ظلّ عاجزاً عن تحديد لون عينيها. الأصفر النقي فيه خضرة أم هو الأخضر الصافي.
كأنه يرى الان بوضوح الشفتين الدقيقتين المضمومتين برقة يحسها الان نائية، الجيد النحيل المدود شديد البياض مائلاً بضعف على الجسد المبلول، كانت تصفق بيديها فقط، بإيقاع خافت، وحين تسأل زهور حسين
قولي شوكت نتلاقى ... يجبن جميعاً بصوت واحد: يوم الأربعاء أغاتي.
كان ذلك يومهن من كل إسبوع، ويضحكن بصخب يشعر به الان مثل أصداء بعيدة ومنهكة، وكانت هي لاتغني مثلهن، نظراتها لها حياتها الخاصة، يسربلها تأمل عاشق لشيء ما خارج هذا الوجود الضبابي.
هل كان يدرك جسامة أن يرى إليها بعينيه الطفليتين، تقف فجأة فينسفح أمامه الحضور الاسر لعريها البليغ، يواجهه أعزلاً ووحيداً محدقاً بإندهاش الى إلتماع قطرات الماء مثل كرات صغيرة من زئبق تتراقص على اللحم المُشبّع بالدف في ضوء الضحى العالي؟
هو ذاته الضؤ النازل من الفتحة الدائرية في السقف زجاجها يشف عن سماء زرقاء تنظر إليهن لاريب، متابعاً خيط الماء الدقيق المنحدر من نهايات الشعر المنسدل في خصلة كستنائية واحدة مطوية بإهمال. خيط الماء النازل ببطء على البطن الضامر غائبا في بقعة الشعر القصير النابت على الربوة الحميمة التقبب بين فخذيها، هناك عند الغموض المحرم المنيع، وهو يحس الألم اللذيذ حينها يسري بين حالبيه، الألم الجديد عليه، هاجساً تبرعم الزهرة بين فخذيه، ضاماً إياهما بحركة غريزية، مصطدماً بالصمت المفاجىء كأنه يلمسه بأصابعه. الصمت البشري القاسي يجسم في أذنيه دوي مرجل الحمام، بأنينه الضاج المهدد كأنه هرير حشد من الذئاب لها عيون تتأجج فيها النيران.
كن مدهوشات تماماً. يحدقن فيه. عيونهن تخفي ضحكاً لم يفلحن في كتمانه. وهو الملتهب تماماً من الخجل، المكتوي بالنيران الخفية، مغمض العينين على حرقة الدمع. كان قد أبقى عينيه مغمضتين وشعر بالأكف الناعمة تطبطبه بحنان، لعله يتذكر الصدر الرؤوم الذي ضمه إليه مهدئاً. كان يشعر فقط، بدفء الجسد الأنثوي ونعومته تحت شفتيه. لدونة الثديين الفتيين، مايزالان مع ذلك صلبين.
ود لو إنه نام هناك الى الأبد، لكنه يسمع لغطهن، تصل إليه أصواتهن، يكلمن زينب أخته الكبرى: عيني زنوبة الولد كبر ... ويسمع زينب تقول لهن بنبرتها الرخيم المرحة الحمد لله ماكو خسائر، كل الممتلكات سالمة ...
ويضحكن جميعاً صاخبات، ويشعر بأن
في كلمات اخته شيأ من الغموض الساحر. إغواء لذيذ فيه مسرات خفية تشير الى أجزاء نجت من خطر ليس جدياً وليس هذا أوانه بعد. حديقة محرمة لايجب دخولها، وأدرك إن الكلمات مثل الثياب تماماً، لابد لها أن تغطي عرياً ما، وإن فيها أيضاً تهديداً خفياً. وشعر أن قلبه مقبوض بقوة، تعتصره بإصرار لايدرك مصدره حدس طفلي يقرأ حروف مستقبل لايفهمه، ولايسمع عندها غير أنين المرجل في الجانب الغربي للحمام، يئن أنينه المكلوم، يحسه رجولياً. وصوت مذياع الحاجة نجاة العطار يبدد الوحشة، بينما تأتيه اصوات الدلاء المدلوقة على الأجساد العارية. وقع انسكابها مكتوم، يدغدغه، فيغمض عينيه الان، على سطوة الألم اللذيذ.
هو ذاته الألم القادم من زمن مضى، كأن يداً خفية تمسد حالبيه، تقود رحيقهما الى النهاية المضمومة لزهرة البوق النابتة بين فخذيه، النهاية المنتفخة في هذه اللحظة، يحسها، ولا يراها تكبر تحت بنطاله.
زمن زينب
يصعد السلم المتاّّكل الدرجات، مستنداً بيده اليمنى الى الحائط، تلامس أصابعه خطوط الفحم والأصباغ الزيتية المرسومة على صفحته، نتاج طفولة صارت بعيدة الان، جزءاً من زمن لايتوقف، زمن سادر، ماض الى وجهته لايريم. يفتح الباب الخشبية لغرفة زينب فتصدر أنينا ممطوطاً، مواء شاكياً، تعانقه الرائحة المعلقة في فضاء الغرفة. يعرفها، تنكش بأصابعها زمنا ولى بعيداً. الذكرى التي تستحيل الى قسوة نقية بمخالب حادة ومصبوغة. تأكّدها صورة الفتاة الضاحكة تركب الدراجة الهوائية وترتدي بنطالاً قصيراً يكشف عن ساقيها وقبعة من الخوص.
كانت الفتاة تبتسم بينما تضع قدمها اليسرى على الأرض، الصورة مقتطعة من مجلة الصين الشعبيّة وملصقة على الجدار، تقادم عليها زمن الغرفة.. كانا يضحكان من عينيها الطوليتين المشقوقتين اللتين تشبهان عيون القطط. وهو يتذكر زينب محاولة تقليدها فتروح تضَيق من عينيها الكبيرتين، عينيها الخضراوين برموشهما التي تشبه السعف المهتز في الريح، وتقول له بصوتها الرخيم: رياض هذه البنت تقود الدراجة بلا عينين ولكن بالنية وحدها! ويضحكان.
ويعرف أن صدى الضحك الان معلق في زوايا الغرفة يعلوه التراب، وإنه على الرغم من ذلك يسمع صداه واهناً. وإنه توقف تماماً في العام 1978، كان ذلك في تموز، وتيقن لحظتها إن سرطان الثدي لايقيم وزناً للعيون الخضر ورموشها التي تشبه السعف المهتز في الريح. وإنه يرى الان، من النافذة، اللافتة الخشبية المكتوبة بخط الرقعة وباللون الأسود "مستشفى الحمَيّات في الديوانية". ويرى الوميض الأحمر لأزهار الرمّان، الوميض المتراقص عبر الفتحات الطولية لجدار المستشفى، الفتحات المستطيلة مثل كوى تطل على عالم أخر، العالم دون مستشفى.
وتتابع عيناه زوبعة صغيرة تكنس إسفلت الشارع وتطيّر الأوساخ وعلب السكائر الفارغة وأوراق الأشجار اليابسة. ترفعها عالياً وتحطّها على الأرض أو لصق الجدران. يرى الريح بأكفّها الشفيفة تطيّر كيساً ورقياً بني اللون، تطوّح به في الهواء كأنما تهدهده، فيروح يدور منساباً ببطء، مرتفعاً عالياً في الفضاء ويبدو صغيراً ثم، وفجأة، يهبط من علوّه الى الأرض ويطير خفيفاً لصق جدران المدرسة الإعدادية المركزية كأنه يريد الإختباء . بعدها يعلو ويغيب من مجال النافذة. النافذة التي يمر عبرها ضؤ الواحدة ظهراً. الضؤ الذي ينير كل شيء تحتويه الغرفة، مظهراً ذرّات الغبار المتراقصة في مستطيل الضوء الساقط. باعثاً الحياة في الخلفية المُشجرة standing nude المعلقة على الجدار من سنين. متأملاً العنوان المكتوب بالإنكليزية للوحة خوان ميرو العارية وقوفاً. شيء ما يشده الى هذه اللوحة، أّّّّصرة يهجسها إزاءها، العارية تنتظر احداً ما. العينان الكبيرتان، هل كانتا خضراوين ولهما رموش مثل سعف تهزه الريح؟
النظرة المتأملة فيها حزن محبوس، رافعة ذراعها اليمنى كما لو إنها تسند رأسها بينما غطى شريط الشعر بلونه الأزرق الفاتح كفها اليمنى كلها. هل شد وضع اليد المرفوعة هذا، الجسد المنيف فبرز النهدان العامران بحلمتيهما القرمزيتن؟ وماذا عن كفها اليسرى؟ كفها المستقرة على ربوة ردفها الأيسر، لا تبين.
يسحره ميرو بتلوينه ماتحت السرة بالأخضر المسود كما لو أنهما متفقان على غموض حميم، لابدَ منه، لهذا الجزء من الجسد الأنثوي. بستان في لحظة الغروب. هذا ما يعتقده، لهذا فهو يطيل النظر الى الخطوط النازلة من الأعلى تؤطر البطن الهضيم، وتزداد إسوداداً حين تصل الى هناك، الى مستقر العالم ومنبع اللذة والألم.
لكن الخلفية المشجرة في اللوحة تحيله الى الأغصان الخضر المورقة على الزجاج البرتقالي اللون للفتحات الثلاث في الطرف العلوي للحمام من جانبه الشرقي، يخترقه ضؤ الضحى الربيعي، فترتسم ظلال الأغصان المورقة بألونها المشعة على الأجساد الجالسة أو المستلقية على دكة المرمر، تتراقص عليها الظلال ُالبرتقالية والخضراء مرتسمة على ماء بركتها النقي.
لها حياتها الخاصة، لغتها وإشاراتها، أصابعها الخفية المدغدغة الحنون، الأصابع التي تجوس، برفق، بكارة محصنة، حديقة محروسة ومسوّرة، جنة عالية، تميد أشجارها المثمرة في فضاء مضبب ومضيء، وجود حلمي لايمنع أطيافه الموجودة من أن تشرق أو تحتجب أوتشرق ثانية من وراء غيوم البخار أو رغوات الصابون،
تتابع ساحر تنظمه حكمة عادلة وخفية. وكان هو جزءاً من تلك الحياة.
أصابع اخته تدعك شعر رأسه الناعم فيحس بحرقة صابون الرقي تقرص عينيه، ويشهق فاتحاً فمه، عندما يدلق الماء الدافيء، شاعرا بارتياح وخدر، خرجا الى الصالة بينما ظل انفه يستاف الروائح العطرة مختلطة برائحة شراب الدارسين. كان قد سألها عن الكتابة النافرة الاحرف على الصفحة الجصية في اعلى الجدار كانت بادية القدم.
زينب، ماهذه الكتابة؟
اي كتابة؟
تلك التي فوق رأس الحاجة نجاة. لا أعرف كيف اقرؤها
آه. تقصد تلك. تقرأ هكذا: اروات لار بغتات
وماذا تعني؟
تعني حديقة النساء. هذا كلام بالتركي
....
ظل معلقاً بالحروف التي اصطادت المعنى. العبارة الثلاثية الكلمات، والتي امسكت بالحقيقة الى الابد. العبارة النافرة الواقعة فوق لوحة المفاتيح المرقمة بقطع صغيرة من الخشب ربطت إليها.
كان ينظر الى الحاجة نجاة، المرأة البدينة العجوز، بيضاء البشرة، تضع المذياع الخشبي الابنوسي اللون مستقرا بجانبها على الطاولة التي صفت عليها قوالب الصابون وحزم الليف.
كان يعرف أن دماءها تركية، لم تغادر ابداً الى اهلها، بقيت مع سيدتها سعاد خانم. السيدة التي تسكن الدار الكبيرة في محلة السراي، الدار المظاهرة للمدرسة الفيصلية. المدرسة الابتدائية تلك بواجهتها الانكليزية الطراز، وتماثيل حديقتها البيض، المرأة التي ورثت ملكية الحمام عن زوجها، امين الصندوق في السراي العثماني في الديوانية قبل مجيء الانكليز.
قالت إنها قضت عمرها في هذا الحمام تديره، حتى بعد أن رحلت سعاد خانم عن الدنيا. هنا يختنق صوتها وتخظل عيناها الرماديتان بالدمع، فيسود صمت قصير، عندها تقول: الموت وحده الذي يبقى ....
كان صوتها يصله مثل غمغمات حلم غريب، صوتها بعيد، يجسم صورة الموت في باله، يحسه قريبا من الكائنات الجميلة، يخطفها بوحشية قابضا عليها بكفيه السوداوين المشعرتين، مطبقا اصابعه الفولاذية على رقابها الرقيقة الهشة، فيسمع صوت انسحاق عظامها ويرى خروج الحياة من اجسادها، الاجساد التي كانت حية تغيب عنها الحياة الى الابد.
كان قد اسند رأسه الى ذراع زينب، وتذكر انها نظرت اليه، بينما كان هو ينظر الى الصورة المعلقة فوق المدخل للرجل الغريب الهيئة. الرجل الذي يعتمر طريوشا وينظر يحدة الى الامام، عيناه مصوبتان الى داخل الحمام، وشاربه الاسود يغطي شفتيه ويؤكد نظرة الحارس اليقظ، الحارس الصامت لـ "اروات لار بغتات". سوف لن يدع احداً يدنِس الحديقة ببركة ماءها النقي وإوزاتها السابحات، لذا فهو يغرز السيف بقوة، في الفسحة مابين ساقيه الطويلتين المنفرجتين، كمن يستعد لقتال محتمل.
بدا أن كل شيء في هيأته يوحي بهيبة معدة كي تصور، طربوشه ونظراته الحادة وسترته السوداء بأزرارها النحاسية وخطوطها الحمر على الذراعين الهامدتين على مقبض السيف.
زينب، من هذا الرجل في الصورة؟
هذا مصطفى بيك زوج سعاد خانم وجَدُ إلهام الحلوة ... وتغمز بعينها ضاحكة ومناكفة للعاشق الصغير ... إلهام التي هناك في الحمام.
تشير الى اللحظة التي غاب فيها تماما عن هذا العالم، اللحظة التي كان يرى فيها الجمال المجرد يغتسل عاريا، تُذكره ببرهة التحديق البريء المذهول امام لذة لا تحتمل، طفل التاسعة من العمر لاتقوى عيناه على احتواء الحسن المتلأليء امامه فتعينه اعضاءه الاخرى، الحُسن الذي ظل يشعر دوما بالهزيمة امامه، يؤكدها احساسه من أنها كانت محروسة من أن تلمس بسطوة الدم العثماني في عروقها، دم اجدادها الاتراك، ظلت دوما، في باله، تفاحة معلقة بغصنها عالية، لاتسقط ولا تُنال.
الصغير يتدلى إلى الأرض
هل قالت له زينب وقتها إنه قد كبر وإنهن لايوافقن على دخوله لـ أروات لار بغتات بعد الآن، وإن الحاجة نجاة هي التي طلبت مني ذلك. قالت: الولد صار "رِجّال" عيني زينب. محاولة أن تقلد طريقتها البغدادية في لفظها للكلمة بأن فخّمت من صوتها وكسرت حرف الراء وشدّدت الجيم. لم يضحك حينها. كان ثمة شيء ما شرس الحضور له حواف دقيقة ومدببة تنغرزعميقاً في بلعومه كلما أراد أن يتكلم، وهو يرى الإتساع الأخضر لعينيها المندهشتين كأنه الخيط الأخير الذي يشده بينما يتدلى هو في فراغ عميق سيفضي حتماً الى الأرض، هابطاً من جنته بلا حواء ولا فاكهة محرمة.
ظل يداوم الحضور كل اربعاء، متأبطاً كتبه المدرسية، واقفاً تحت مظلة الإسبست الخفيضة لمدبغة السيد نور، منتظرا معجزة ما، برقا يشق الفضاء والجدران المرمرية الراسخة على بعد أمتار منه، فينكشف النور المحبوس في ذاك الفضاء الضبابي، مظهرا "أروات لار بغتات" بإوزاتها البشرية وبركة مائها النقي، حديقة من الضوء الصافي. فردوس سقط خطأ في بقعة كهذه.
خطأ تؤكده الرائحة الكريهة المنبعثة من الجلود المعدة للدبغ في مدبغة السيد نور، ويجسمه باعة الباجة بقدورهم المعدنية الكبيرة تتأجج تحتها النيران، واضعين رؤوس الخراف الصلعاء المسلوقة عليها، عيونها الجاحظة تنظر بدهشة مسكينة. دهشة سيتذكرها بعد سنين وهو يشهد في مكان ما من قصر النهاية، السجين الذي شدّ الى إفريز السلم الخشبي الابيض في الصالة الملكيّة في قصر الرحاب.
عندها جيء بهم مكتوفين وقد اجلسوا في صفين على البلاط الأرقش البارد، يحدقون في رعب خالص بالقنينة الزجاجية الطويلة المكسورة الفوهة، تثلم عنقها فبرزت حوافها منتصبة دقيقة النهايات تشبه الحراب المشرعة، تبرق تحت أضواء الصالة التي كانت ملكية. كان السجين المتورّم العينين والذي تجمد الدم على فتحتي أنفه وشاربه ينظر الى رجال الأمن والى القنينة المنتصبة على البلاط، في تلك اللحظة يدفع طفل في العاشرة من العمر الى وسط الصالة يرتدي دشداشة بنية مقلمة بخطوط بيضاء، ولأنّه كان مرعوباً فقد إتسعت عيناه
السوداوان بذلك الضرب من الحيرة المسكينة.
عندها، إنتفض السجين المربوط الى إفريز السلم كمن يريد أن يكسر القيد وهو يصرخ بالرجل القصير الأعور، الرجل الذي بيده المصائر كلها:
ناظم الولد ماله ذنب. إترك الطفل ناظم .... ناظم الطفل مايعرف شني حزب
محركاً رأسه كمن يرفض أن يصدق أمراً ما، بينما تقدم رجلا أمن من الطفل ونضوا عنه دشداشته فبدا جسده، تحت ضوء الصالة، شاحباً ونحيلا، كان يتنفس بصعوبة وهو يبكي بذاك النغم المكسور الجارج ناظرا الى الأب، المكبل. والأب، كالمأخوذ، يكرر لازمته:
.....ناظم، الطفل .... لا .... .شتريد ناظم .... بس الطفل لا
كانوا قد نضوا عنه لباسه الداخلي حين صفق الرجل القصير بيديه، كما لو كان قضاء لايرد، أمسك كل واحد منهما بقدم وذراع فبدا الطفل كما الجالس في الفضاء. ثم بقوة أجلساه على القنينة المثلمة الحواف.
كانت صرخة واحدة فقط، لم تكن أبداً صرخة طفل في العاشرة من عمره. كانت صرخة لحشد لا يعّد. كما لو كانت لشعب أُجلس بقوة على عنق زجاجة، لاشك أن بغداد كلها قد سمعتها، لابد أنها إستيقضت من نومها مذعورة لكن هل حقاً سمعت بغداد الصرخة؟
لم يكن يدري تماما طول الفترة التي ظل فيها غائبا عن العالم، لكنه يدرك اللحظة التي غاب فيها عنق الزجاجة في جسد الطفل، واللحظة التي إلتقت فيها عيناه بالعينين السوداوين وفيهما كل رعب العالم وحيرته.
وأدرك لحظتها أيضاً أن الاشياء جميعها قد إصطبغت باللون الأحمر. وحين استيقظ من غيابه رأى أن جدران الصالة الملكية البيضاء كانت قد تلطخت بالدماء التي تفجرت من جسد الطفل. ولم يكن يعلم على وجه اليقين إن كان زملاءه أحياء أو اموات ذلك أنهم كانوا جالسين بلا حراك في بركة من بول وخراء ودم. ولعله فقط ظل مشدودا الى عيني الطفل الساكنتين أمامه فيهما تلك الدهشة النقية والحائرة ادرك وقتها أن المسافة بين الموت والحياة، في تلك البلاد، أقصر كثيرا من صرخة طفل يمزّق.
كانت عيناه تتأمّلان الجسد الصغير الملقى وسط الصالة، بينما تلتمع أمام عينيه العبارة الناصعة الذهبية الحروف على القطعة الخشبية البنية، العبارة الوحيدة الحقيقية في هذا العالم، تلك التي لايمكن التشكيك بسطوتها وقدريتها والمكتوبة بخط الديواني جلي، السيد مدير الأمن العام اللواء ناظم كزار، معلقة على باب الغرفة المقابلة له.
ولكن من أين الطريق الى أروات لار بغتات؟
فردوسه المستدعى بالرؤى والألوان، زمن سلامه الذي نأى، يتذكره معلقا على جدران قاعة الأورفلي في بغداد،
يوتوبيا الفطيرة، كما يصفها أستاذه فائق حسن، كان ذلك معرضة الأول، يقول له:
إبني رياض، ضع قدميك على هذه الأرض هنا، هذه قاعة الأورفلي.
وضرب بحذائه البلاط الإسمنتي.
هذه أرض صلبة في بلاد لها وجود واقعي، تمام، ارسم شي آخر.
كان غليونه يرتجف وهو يتكلم وعيناه الصغيرتان تقدحان تحت حاجبيه الكثيفين.
ماذا يريد؟
هل تحتمل جدران القاعة لوحة تُصوّر طفلا يتمزق بقينينة مكسورة؟
كان يفكر فيه. في جدرايته التي في ساحة التحرير ببغداد، بحمامها الابيض المغسول الريش وعمالها ببدلاتهم الزرق. تساءل: كم فيها من العراق الواقعي، العراق الذي يدعو اليه؟ العراق الذي كان بالنسبة اليه دوما شيئا خارج التعريف، كيانا رجراجا، غموضا مضحكا ومبكيا في ان، أُحجية ابدية تنطوي على سرها وسخريتها وهي تمد لسانها الطويل ....
فكر فيه، في موته ووصيته ان يُحرق، لم يرد ان يتحلل في تراب الوطن، في عراق له وجود واقعي، الرسام الذي احبه على الرغم من قسوته، هو الذي حبس روحه الحرة ورمادها في قارورة، روحه التي كانت تشبه خيوله السابحة في صحراء بلا افق، تحولت الى رماد يستقر هامدا في قعر قارورة، مناسبة للتأ مل، شيئا يطرد الوحشة عن وحدة زوجته الباريسية.
تساءل: اي مرارة تلك؟
عندها فقط حاول ان يحمي روحه من التفكير بعراق قاس. ان يمعن في السفر الى ازمان بعيدة. الى ازمان ليس فيها بشاعة بلدان لها (وجود واقعي). بلدان لها القدرة في اي زمان على ان تعلقك من قدميك في كلاّب مروحة سقفية، ستكون جميع احشاءك متجهة الى الاسفل، بالاتجاه المضاد لمنظور الرسم، العالم مقلوبا كما لو كنت في لوحة لمارك شاغال، لوحة من تلك البلاد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*نشرت ضمن مجموعته القصصية (كلاب الآلهة) الصادرة عن دار التكوين في دمشق سنة 2008. وفي عدة مواقع ثقافية.








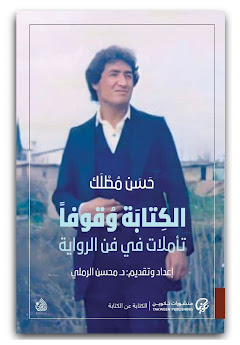


















ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق